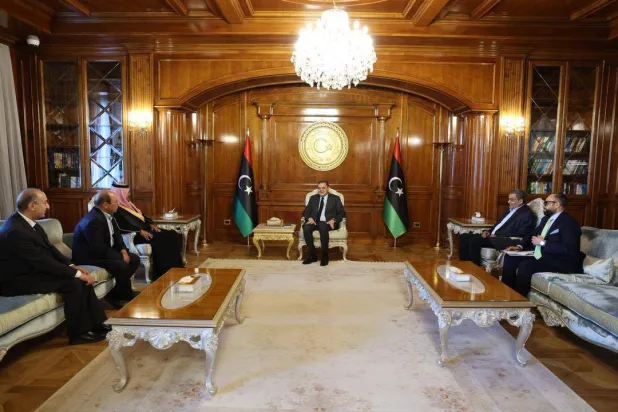Arab
تمرّ سورية في مرحلة مصيرية من تاريخها الاقتصادي، يقف عندها القطاع العام في قلب اختبار وجودي معقد يمثل حالة فريدة، وإن كانت متشابهة في جوانب كثيرة مع تجارب عربية مجاورة. ويبرز التعامل مع القطاع العام أهم المؤشرات التي سترسم شكل سورية الجديدة. فقضية القطاع العام هنا ليست مجرد موضوع اقتصادي يتعلق بمكلية وسائل الإنتاج، بل يحمل أبعاداً اجتماعية وسياسية.
حاولت الجزائر عبر سنوات طويلة إصلاح قطاعها العام الثقيل، الذي تشكل في حقبة التأميمات الاشتراكية، لكنها اصطدمت بمقاومة شبكات المصالح، ما أدّى إلى بطء الإصلاح واشتعال احتجاجات شعبية. ودفعت مصر ثمناً باهظاً لخصخصة سريعة وغير شفافة في تسعينيات القرن الماضي، تحوّلت فيها أصول الدولة إلى مراكز قوى اقتصادية جديدة، فوسعت الفجوة الاجتماعية وزادت السخط الذي تفجر لاحقاً (تقرير البنك الدولي عن التحول الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 2009). أما العراق، فقد شهد بعد 2003 تفكيكاً كاملاً لدولة القطاع العام دون بديل مؤسّسي، ما ولّد فوضى وفساداً طاول كل مفاصل الاقتصاد (تقرير "إعادة الإعمار والفشل المؤسسي في العراق"، معهد بروكينغز، 2007). تضع هذه الدروس المجاورة المسار السوري على محك التاريخ: هل سيتمكن من تجنب فخ "الإصلاح الوهمي" الذي يحول الاحتكار العام إلى احتكار خاص، أو فخ "الصدمة المؤسّسية" التي تدمر ما تبقى من نسيج اقتصادي؟
مع تولي بشار الأسد المخلوع السلطة عام 2000، أطلقت الإدارة الجديدة خطاباً إصلاحياً صورياً تحت عنوان التطوير والتحديث، سرعان ما تبدد مع ربيع دمشق ومحاولة الطبقة الوسطى لعب دور اقتصادي واجتماعي لم يسمح لها بذلك
بدأت القصة من نقطة مختلفة تماماً في منتصف القرن العشرين، ففي مرحلة ما بعد الاستقلال، تميّز الاقتصاد السوري بدرجة ملحوظة من الانفتاح والليبرالية النسبية، حيث كانت النخب التجارية والزراعية في حلب ودمشق هي المحرك الرئيسي للاقتصاد، وكانت السياسات تعكس مصالحها إلى حد كبير. كان القطاع العام محدوداً ويتركز في المرافق الأساسية، ولم يكن تأميم شركة كهرباء دمشق عام 1951 سوى إعلان استثنائي عن رغبة الدولة الناشئة في السيطرة على مفاصل حيوية استراتيجية. لكن المسار انعطف بشكل جذري مع الوحدة السورية المصرية (1958-1961)، التي طبقت سياسات تأميم واسعة مستوحاة من النموذج الناصري، مستهدفة البنوك والشركات الصناعية والتجارة الخارجية، بهدف كسر شوكة الإقطاع والرأسمالية الكمبرادورية وبناء قاعدة اقتصادية للوحدة العربية.
وبلغ هذا المنحى ذروته مع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، حيث شهد مطلع عام 1965 تأميم 115 شركة خاصة دفعة واحدة، في واحدة من أكبر العمليات من نوعها في تاريخ البلاد (مرسوم تأميم 115 شركة، يناير/ كانون الثاني 1965)، شملت قطاعات حيوية مثل الإسمنت والسكر والنسيج والصناعات الكيماوية. كان القرار، المُغطّى بخطاب اشتراكي، يهدف إلى تحقيق أهداف متعددة: اقتصادياً لبناء قاعدة صناعية وطنية تحت سيطرة الدولة تحقيقاً للاستقلال الاقتصادي، واجتماعياً لتوزيع الثروة وإيجاد فرص عمل عبر توسيع الجهاز البيروقراطي والصناعي التابع للدولة، وسياسياً لتحطيم القوة الاقتصادية للنخب التقليدية المعارضة وإيجاد طبقة وسطى جديدة مرتبطة مصلحياً بالدولة. مع نهاية الستينيات، أصبح القطاع العام المالك والمشغل شبه الوحيد للصناعات المتوسطة والكبيرة، وبات ينتج ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي في السبعينيات (تقديرات المجموعة الإحصائية السورية، 1975)، محولاً نفسه إلى المحرك الرئيسي للاقتصاد ومزود الوظائف الأول.
إصلاحات شكلية ومقاومة للإصلاح والتغيير (2000-2010)
مع تولي بشار الأسد المخلوع السلطة عام 2000، أطلقت الإدارة الجديدة خطاباً إصلاحياً صورياً تحت عنوان التطوير والتحديث، سرعان ما تبدد مع ربيع دمشق ومحاولة الطبقة الوسطى لعب دور اقتصادي واجتماعي لم يسمح لها بذلك، تلاشت الوعود. ولكن بسبب تراجع الإيرادات النفطية وعوائد القطاع العام الاقتصادي، كان لا بد من طرح بدائل اقتصادية قدّمها مفكرون وباحثون اقتصاديون، لا تنفي مكاسب القطاع العام ولا تستمر في سياسة النزيف المستمرة للموازنة نتيجة الخسائر والهدر الكبير الذي كان يعاني منه، توجت هذه المحاولات بالخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) تحت شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي". على الورق، مثلت الخطة محاولة جريئة لتصحيح المسار عبر تحول تدريجي نحو آليات السوق مع الحفاظ على دور اجتماعي للدولة. وقد حققت الخطة، على المستوى الكلي، إنجازات مالية وإحصائية بارزة: فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من حوالي 22 مليار دولار عام 2005 إلى ما يقارب 60 مليار دولار عام 2010 (تقارير البنك المركزي السوري، 2011)، وحقق الاقتصاد معدل نمو متوسطاً بلغ حوالي 5.7% سنوياً خلال فترة الخطة، وتم الحفاظ على مستوى منخفض جداً للديون الخارجية، بل وانخفض العجز الكلي في الموازنة إلى حدود 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي (وزارة المالية السورية، التقرير السنوي 2010).
ولكن القصة الحقيقية تكمن في ما تحت هذه الأرقام. فالخطة، رغم أهدافها الكلية، واجهت مقاومة عنيفة للتغيير من داخل النظام نفسه. اصطدمت ركائزها الإصلاحية (مثل إصلاح الدعم، وخصخصة الشركات الخاسرة، وإدخال الحوكمة) بجدار من المعارضة من النخب الحاكمة التقليدية في حزب البعث وبيروقراطية الدولة، الذين رأوا في أي إصلاح حقيقي تهديداً لامتيازاتهم وشبكات مصالحهم المرتبطة بالقطاع العام. تمت عرقلة التحوّل الحقيقي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، وتحولت بعض عمليات التحرير الجزئي للاقتصاد إلى عملية معقدة للغاية، بينما بقي الفساد الإداري والهيكلي من دون معالجة. نتيجة لذلك، فشلت الخطة في تحقيق تحول اقتصادي محوكم أو تحقيق أهدافها المعلنة. فقد بقيت معدلات الفقر مرتفعة (حيث قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن حوالي 30% من السكان كانوا تحت خط الفقر عام 2010)، واستمرت البطالة، خاصة بين الشباب، عند مستويات عالية (حوالي 20% حسب تقديرات منظّمة العمل الدولية ILO ،2011). والأهم، بقيت الإنتاجية متدنية والاقتصاد ريعياً يعتمد على النفط والتحويلات، من دون تنمية قطاع خاص حقيقي ومبتكر. لقد كشفت هذه الفترة أن مقاومة التغيير من الداخل كانت أكبر عائق أمام أي إصلاح، ما حوّل شعار "اقتصاد السوق الاجتماعي" إلى واجهة لنموذج غير قادر على معالجة التناقضات الجوهرية. لقد كانت مقاومة التغير عملية ممنهجة قام بها النظام البائد كي يقول إن المشكلة هي ليست بالقطاع العام وإنما في جوهر وبنية الاقتصاد السوري غير القابل للحل، لقد قاومت النخب الحاكمة التغير بشكل عنيف حفاظاً على المكاسب والمنافع، لأن الحوكمة والإدارة الرشيدة ستكون في غير صالحهم وسوف تفقدهم المزايا والمنافع التي كانوا يحصلون عليها. لقد كانت تجربة الخطة الخمسية العاشرة مثلاً واضحاً لمحاولة فشل الإصلاح إن لم يكن مدعوماً بإرادة سياسية واعية وحقيقية.
مرحلة الحرب: تفكيك العقد الاجتماعي وانهيار المكتسبات (2011-2024)
شكلت الحرب التي شنها النظام البائد على سورية وشعبها عام 2011 زلزالاً وجودياً لم يهز البنية المادية للقطاع العام فحسب، بل دمر العقد الاجتماعي القديم برمته الذي بني على خدمات الدولة. قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بأكثر من 300 مليار دولار (تقدير الأمم المتحدة والبنك الدولي في تقرير "الخسائر الاقتصادية في سورية"، 2022).
في هذا المشهد الكارثي، انهارت المكتسبات التاريخية للقطاع العام الواحد تلو الآخر. فقد دُمِّر نصف المدارس وأصبح ربع المستشفيات إما مدمراً أو يعمل بقدرة محدودة (تقرير "الأطفال تحت النار"، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، 2022 وتقرير منظمة الصحة العالمية حول المرافق الصحية في سورية، 2023). وعوضاً عن نظام الدعم الاجتماعي العمومي والشامل، لجأ النظام إلى سياسة "البطاقة الذكية" بدءاً من 2015، والتي قُصِرت على المناطق الخاضعة لسيطرته، وتم من خلالها تحرير أسعار العديد من المواد الأساسية تدريجياً، مع بقاء دعم رمزي ضعيف. أدى هذا إلى انهيار القدرة الشرائية، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها (بيانات سوق الصرف غير الرسمي، 2023). وارتفعت نسبة الفقر المدقع من حوالي 30% قبل الحرب إلى أكثر من 90% بحلول 2023 (تقرير "الاحتياجات الإنسانية في سورية"، برنامج الأغذية العالمي WFP، 2023). كما بلغت البطالة، خاصة بين الشباب، مستويات قياسية تجاوزت 50%، ما أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات والشباب، حيث هاجر ما يقدر بـ6.7 ملايين سوري إلى الخارج (تقرير "الاتجاهات العالمية للنزوح القسري"، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 2023). تحولت اتحادات العمال والفلاحين من منظمات شعبية إلى أدوات بيروقراطية فارغة المضمون. وخلال هذه الفترة، واصل النظام سياسة التحول القسري والنفعي، فأعاد هيكلة الدعم وقلصه، وأصدر قوانين مثل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لتشجيع شراكات مشبوهة مع رجال الأعمال المقربين، في محاولة للتكيف مع اقتصاد الحرب والانزلاق نحو "اقتصاد النهب والمحاصصة". ولقد عملت حكومة النظام السابق على تفكيك بنية القطاع العام عبر مشاريع هيكلية، كقانون التشاركية في صيغه العديدة من أجل التخلص من القطاع العام ومن أجل محاولة تقليل العجز والدين وتحسين مؤشرات المالية العامة، في ظل تضخم جامح وتراجع لسعر الصرف وصل إلى مستويات غير مسبوقة 1500 ليرة للدولار. لم يكن القطاع العام بمنأى عن تفكير القيادات والنخب، ليس من أجل إصلاحه أو تدعيمه وإنما من أجل التخلص منه بطرق عدة، كقانون التشاركية، فكان منها مرفأ طرطوس واللاذقية ومعامل الأسمدة والفوسفات والإسمنت ومطار دمشق والمنافذ البرية مثالاً على نية الحكومة السابقة في التخلي عن أبسط مقومات النهج الاشتراكي أو حتى اقتصاد السوق الاجتماعي وعدم التفريط بالمطارح الاقتصادية السيادية.
النماذج المتاحة أمام سورية لا تقتصر على تجارب الحرب الأهلية. فهناك نماذج تنموية استراتيجية تثبت أن الخيار ليس ثنائياً بين الدولة الشمولية والسوق المتوحش
مرحلة ما بعد التحرير وصراع الهوية الاقتصادية
بعد سقوط النظام السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ورثت الحكومة الجديدة إرثاً كارثياً لواقع وصفته التقارير الدولية بـ"الأزمة الإنسانية والتنموية الأكبر في العالم الحديث". وجدت السلطات نفسها أمام دولة شبه مفككة: خزينة عامة فارغة تماماً من العملة الصعبة بعد سنوات من العزلة والعقوبات، وبنية تحتية مدمرة قدرت تكاليف إعادة إعمارها بمئات المليارات من الدولارات (تقرير "مستقبل سورية: خارطة طريق للتعافي"، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، 2024). في قلب هذه الكارثة، يقف قطاع عام خاسر ومتضخم، يعتمد عليه أكثر من 1.4 مليون موظف برواتب هزيلة لا تتجاوز 30 دولاراً شهرياً، في وقت يعيش فيه أكثر من 85% من السكان تحت خط الفقر (تقرير "الأمن الغذائي والتغذوي"، برنامج الأغذية العالمي، 2024). تواجه الحكومة الجديدة، إذن، معضلة وجودية تتجاوز الخيار الأيديولوجي المجرد، لترتبط بمسألة إنقاذ مجتمع من الانهيار التام وإعادة بناء مؤسسات دولة من العدم.
في سعيها المحفوف بالمخاطر إلى رسم مسار اقتصادي جديد، لا تملك سورية رفاهية التجريب، ما يجعل من دروس الدول التي خرجت من حروب أو حققت قفزات تنموية دليلاً لا غنى عنه. فقد فشل لبنان ما بعد 1990 في إصلاح قطاعه العام والفاسد، متمسكاً بنظام المحاصصة الذي أدّى إلى انهيار مالي واجتماعي كامل. بالمقابل، تبنت كوسوفو بعد 1999 نموذجاً قائماً على خصخصة ممنهجة واعتماد كبير على المساعدات الخارجية، ما حقق نمواً سريعاً لكنه خلق اقتصاداً هشاً وتبعية (تقرير "الانتقال الاقتصادي في كوسوفو"، البنك الدولي، 2010). أما العراق بعد 2003، فقدم النموذج الأكثر قتامة عبر الوقوع في فخ "الخصخصة المفترسة" والفساد المنظّم، حيث تحولت ثروة النفط إلى مصادر إثراء لطبقات سياسية جديدة (تقرير "الفساد وإعادة الإعمار في العراق"، منظمة الشفافية الدولية، 2013).
غير أن النماذج المتاحة أمام سورية لا تقتصر على تجارب الحرب الأهلية. فهناك نماذج تنموية استراتيجية تثبت أن الخيار ليس ثنائياً بين الدولة الشمولية والسوق المتوحش. فالصين، منذ إصلاحات دنغ شياو بينغ عام 1978، رسمت مساراً يجمع بين قيادة الدولة الصارمة وحيوية السوق، حيث حافظت على سيطرة كاملة على القطاعات الإستراتيجية عبر شركات حكومية عملاقة، بينما حرّرت الآلاف من القطاعات التنافسية، ما انتشل أكثر من 800 مليون شخص من الفقر المدقع (تقرير "الفقر والرخاء المشترك"، البنك الدولي، 2022). الدرس الأساسي هنا هو إمكانية التحول التدريجي المدروس حيث تكون الدولة هي المهندس الرئيسي. وفي التجربة الألمانية بعد إعادة التوحيد، واجهت الحكومة الألمانية مشكلة قطاع عام ضخم وغير كفء في الولايات الشرقية السابقة. تم التعامل مع هذه المشكلة من خلال إنشاء "هيئة التراث" (Treuhandanstalt)، التي قامت خلال أربع سنوات بتفكيك أو خصخصة 8500 شركة. لكن الفارق الجوهري هو أن هذه العملية كانت مدعومة بتمويل ضخم من ألمانيا الغربية وبشبكة أمان اجتماعي متطورة، وهما عاملان غير متوفرين في الحالة السورية (تقرير "التحول الاقتصادي في ألمانيا الشرقية"، معهد البحوث الاقتصادية الألماني DIW ،2000).
وفي القارّة الأفريقية، قدمت رواندا، بعد الإبادة الجماعية عام 1994، نموذجاً يرتكز على الحوكمة الصارمة ومكافحة الفساد باعتباره أولوية قصوى، نجحت من خلاله في جذب استثمارات موجهة وحققت متوسط نمو مذهل بلغ حوالي 8% سنوياً لعقدين (تقرير "معجزة رواندا الاقتصادية"، البنك الدولي، 2020). هذه التجربة تثبت أن جودة المؤسسات هي الركيزة الحقيقية لأي معجزة اقتصادية. أما ماليزيا فأظهرت قوة السياسة الصناعية الذكية عبر إيجاد "صناعات وطنية أبطال" بدعم الدولة، مع انفتاح كامل على الاستثمار الأجنبي لنقل التكنولوجيا، محققة قفزة تنموية غير مسبوقة (تقرير "السياسة الصناعية في ماليزيا"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015). ومن أميركا اللاتينية، جاء درس البرازيل في الجمع بين التنمية والعدالة، حيث ساهم مزيج من استثمارات القطاع العام وبرامج التحويلات النقدية الضخمة ("بولسا فاميليا") في انتشال حوالي 29 مليون شخص من الفقر المدقع بين 2003 و2014 (تقرير "برنامج بولسا فاميليا وتأثيره على الفقر"، البنك الدولي، 2016). لكن ثمة تحذيرات أيضاً من تجربة تركيا، التي تظهر مخاطر نموذج النمو القائم على التحالفات الوثيقة بين الدولة وقطاع أعمال محسوب، ما أدّى إلى تضخم جامح وتآكل في استقلالية المؤسسات (تقرير "الاستقرار الاقتصادي الكلي في تركيا"، صندوق النقد الدولي، 2023).
في هذا السياق الكابوسي، تتحرّك الحكومة السورية الجديدة ضمن حقل ألغام. فرغم أنها لم تعلن رسمياً عن نيتها الاقتراض من صندوق النقد الدولي، إلا أن الضغوط العملية تدفعها نحو سياسات تتماشى مع اقتصاد السوق الحر باعتبار ذلك مساراً متصوَّراً لاستقطاب الاستثمارات الضخمة. يتركز نهجها الأولي على خصخصة واسعة لشركات حكومية وتحرير تدريجي للأسعار والدعم. هذه الإجراءات هي ردة فعل عملية على إفلاس الخزينة واستحالة إصلاح منظومة فاسدة من داخلها، وليست بالضرورة عقيدة نيوليبرالية صرفة. فالحكومة الحالية تجد نفسها أمام واقع اقتصادي صعب والخيارات مرهونة بالتحسن الإنتاجي وإعادة الإعمار، وهي أمور ليست بالمتناول في الأمد القريب.
لذلك، فإن الطريق السوري الواقعي يجب أن يكون مركّباً وذكياً، مستفيداً من هذه الدروس جميعاً: تبنّي الحوكمة الصارمة ومكافحة الفساد على الطريقة الرواندية باعتبارها شرطاً أساسياً، واعتماد سياسة صناعية وتجارية انتقائية وطويلة الأمد تستلهم نجاح ماليزيا، والحفاظ على دور اجتماعي للدولة في تقديم الخدمات الأساسية وحماية الضعفاء، متعلمين من الإيجابيات في النموذج البرازيلي، وتفادي فخ اقتصاد المحسوبيات والاستدانة غير المنتجة، كما حذّرت منه تجربة تركيا. في النهاية، لن يُقاس نجاح التحوّل بسرعة بيع الأصول، بل بقدرة الدولة على تحويل مؤسّساتها من أدوات للولاء والفساد إلى أدوات للإنتاج والعدالة. هذا هو التحدّي الحقيقي الذي سيرسم مستقبل سورية.
لعبت البيئة السياسية المغلقة دوراً مركزياً في تسريع تدهور نموذج دولة الرعاية. فقد رسّخ النظام منظومة أمنية متشعبة حدّت من إمكان المساءلة والشفافية، ما جعل مؤسّسات الدولة تعمل في فضاء مغلق تحكمه الولاءات لا القواعد المؤسسية
الخيارات والسيناريوهات المتاحة
تبدو الخيارات المتاحة جميعها صعبة، فمسار الخصخصة السريع يحمل مخاطر تحوّل الأصول العامة إلى ملكيات خاصة لشبكات النفوذ، بينما قد يؤدّي إلى تدهور اجتماعي في غياب البدائل الوظيفية. ومن ناحية أخرى، يتطلّب الإصلاح التدريجي للقطاع العام موارد مالية وخبرات إدارية غير متوفرة في الوقت الحالي، كما يحتاج فترة طويلة في وقتٍ تتطلب فيه الأزمة الاقتصادية حلولاً سريعة. ربما يكون المخرج في تبنّي نهج متدرّج يراعي التعقيدات الواقعية. يبدأ بتجميد التوظيف الجديد في القطاع العام، ثم إجراء مسح دقيق لواقع كل مؤسّسة، وتصنيفها حسب أولويات الإصلاح. المؤسسات الاستراتيجية التي تحقق ربحاً يمكن إصلاحها بمنحها استقلالاً إدارياً ومالياً. أما المؤسسات الخاسرة وغير الاستراتيجية فيمكن حلها تدريجياً مع تطوير برامج إعادة تأهيل للعاملين. لكن كل هذه الحلول تبقى نظرية في غياب الشروط الأساسية للإصلاح، فبدون حوكمة رشيدة وشفافية ومحاسبة حقيقية، ومع استمرار هيمنة شبكات المصالح، ومع غياب الرؤية الاقتصادية الشاملة، فإن أي محاولة إصلاح قد تتحوّل إلى فرصة جديدة للفساد ونهب المال العام.
يمثل القطاع العام السوري اليوم مرآة عاكسة لأزمة التنمية في البلاد، فهو يحمل في تاريخه إرثاً من الإنجازات الاجتماعية التي لا يمكن إنكارها، لكنه يحمل أيضاً إرثاً من الفشلين الاقتصادي والإداري، سببه النظام السابق الذي لا يمكن الاستمرار فيه. يتطلب الخروج من هذا المأزق أكثر من قرارات تقنية، بل يتطلب إعادة نظر شاملة في نموذج التنمية نفسه، وفي العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمع. وهو تحدٍ ليس اقتصادياً فحسب، بل هو في جوهره تحدٍ سياسي واجتماعي يلامس أسئلة الهوية والعدالة والتطور في سورية ما بعد الحرب.
تعميم الخدمات ثم تحوّلها إلى أدوات للسيطرة
شهدت العقود الثلاثة لحكم نظام حافظ الأسد البائد تبلور دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية الشاملة، التي مثلت الوجه الإيجابي الأول للقطاع العام. فقد قامت الدولة، من خلال استثمارات ضخمة، بتعميم التعليم المجاني من الابتدائي إلى الجامعي في المدن والأرياف، ما رفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من حوالي 30% في الستينيات إلى أكثر من 80% بحلول التسعينيات (تقرير "التعليم للجميع"، اليونسكو، 1995). كما جرى تعميم الصحة المجانية عبر بناء شبكة وطنية من المستشفيات والمراكز الصحية، ساهمت في خفض معدل وفيات الأطفال ورفع متوسّط العمر المتوقع بشكل ملحوظ (تقرير "الصحة في العالم"، منظمة الصحة العالمية، 2000). ووسعت الدولة هيمنتها لتشمل توفير الخدمات الأساسية المدعومة، حيث سيطرت مؤسسات القطاع العام بشكل كامل على إنتاج وتوزيع الكهرباء والمحروقات، وأنشأت نظام الكوبونات (البطاقات التموينية) لتوزيع المواد الغذائية الأساسية (كالسكر والشاي والقمح) بأسعار رمزية، ما ضمن حداً أدنى من الأمن الغذائي للمواطنين (بيانات المؤسسة العامة للتجارة الداخلية، 1998). كما تم إنشاء منظومة السكن الجماعي للموظفين والعمال، وتأسيس اتحادات شعبية مثل اتحاد الفلاحين واتحاد العمال، وتمويل الجمعيات الفلاحية وتقديم دعم كبير للزراعة عبر المؤسسة العامة للحبوب والإصلاح الزراعي. شكلت هذه السياسات عقداً اجتماعياً غير مكتوب، حيث وفرت الدولة الخدمات والضمان الاجتماعي مقابل الولاء السياسي. ولقد ساهمت هذه السياسات فعلا في نمو ما يسمى بالطبقة الوسطة التي حملت عملية التغير الاقتصادي والاجتماعي في سورية خلال تلك الفترة.
لكن هذا الوجه الإيجابي بدأ بالتآكل مع تحول القطاع العام نفسه. فبعد حرب 1973، أدّى تدفق الريع النفطي العربي (المقدّر بنحو ملياري دولار سنوياً آنذاك وفق تقديرات صندوق النقد العربي، 1975) إلى تضخم هائل في حجم القطاع وعدد العاملين فيه، دون أن يقابله تحسن في الإنتاجية أو الكفاءة. أصبح التوظيف في المؤسسات الحكومية وسيلة لمكافأة الولاء وإيجاد شبكات محسوبية، حيث جرى استيعاب أعداد هائلة تفوق الحاجة الفعلية، ما أدّى إلى تحوّله إلى "مخزن للبطالة المقنعة". في الوقت نفسه، تحوّلت مؤسّسات الدولة إلى ساحات للفساد المنهجي وهدر المال العام، حيث تم توجيه العقود والمشاريع الكبرى لصالح أفراد ومجموعات مقربة من مراكز النفوذ. بلغت ذروة هذه المرحلة مع الأزمة الاقتصادية في الثمانينيات، التي كشفت هشاشة النموذج القائم. وجاء قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ردة فعل، مقدماً إعفاءات سخية لجذب رأس المال السوري المغترب، في محاولة لإنعاش الاقتصاد من دون إصلاح حقيقي للقطاع العام الفاسد والخاسر. ظل القطاع العام خلال هذه الفترة بمثابة "بقرة حلوب" لشبكات المصالح، حيث قدرت خسائر شركاته، وفق تقرير اقتصادي حكومي غير منشور عام 2008، بحوالي 418 مليار ليرة سورية (ما يعادل 8.5 مليارات دولار آنذاك)، وهو رقم يكشف حجم الهدر والفساد الذي استشرى تحت غطاء الشعارات الاشتراكية.
إلى جانب التحولات البنيوية داخل القطاع العام، لعبت البيئة السياسية المغلقة دوراً مركزياً في تسريع تدهور نموذج دولة الرعاية. فقد رسّخ النظام منظومة أمنية متشعبة حدّت من إمكان المساءلة والشفافية، ما جعل مؤسسات الدولة تعمل في فضاء مغلق تحكمه الولاءات لا القواعد المؤسسية. أدى ذلك إلى تآكل تدريجي في جودة الخدمات العامة التي كانت في يوم من الأيام ركيزة "العقد الاجتماعي"، إذ بدأت المدارس تعاني من نقص التمويل وضعف البنية التحتية، وتراجع مستوى الرعاية الصحية بفعل تهالك التجهيزات وهجرة الكوادر المؤهلة نحو القطاع الخاص أو الخارج. وفي المقابل، صعدت طبقة جديدة من كبار التجار والوسطاء المرتبطين بالأجهزة، مستفيدة من اقتصاد الظل والامتيازات الحصرية في الاستيراد والتعاقد العام. هذا التحول البنيوي عمّق الفجوة بين الخطاب الاشتراكي الرسمي والممارسة الفعلية، وأدّى إلى تآكل الثقة العامة بالدولة باعتبارها مقدّمة الخدمات وضامنة العدالة الاجتماعية. ومع دخول التسعينيات، بات واضحاً أن نموذج الرعاية القديم قد استُهلك بالكامل، وأن البلاد مقبلة على مفترق طرق اقتصادي واجتماعي لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات جذرية غابت الإرادة السياسية لتنفيذها.


Related News

مؤتمر دولي في الرياض يبحث استدامة المدارات الأرضية
aawsat
11 minutes ago

تقنية مبتكرة تعيد الأمل لفاقدي البصر
aawsat
13 minutes ago