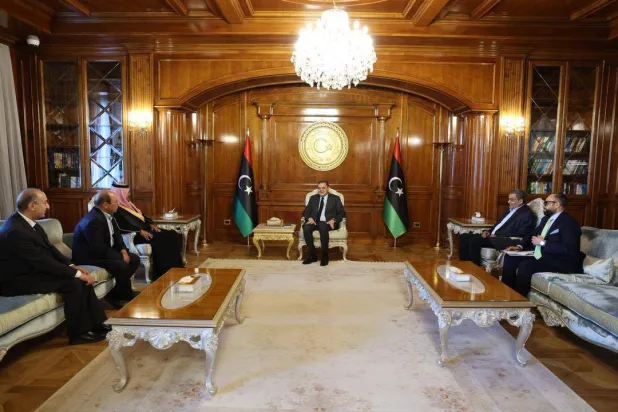Arab
اعتاد السوريون، على امتداد سنوات طويلة من الحرب والانقسام، النظر إلى بلادهم من موقع المتفرّج القَلِق أو الضحية الغاضبة. تشكّلت علاقة مشوّهة مع السياسة، قوامها الانتظار، أو الارتهان للخارج، أو التمسك بمظلومية حقيقية تحوّلت مع الزمن إلى عجز جماعي عن الفعل. غير أن اللحظة السورية الراهنة، بكل ما تحمله من تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، لم تعد تسمح بهذا الترف. فما يجري اليوم في دمشق وحلب والشمال الشرقي يفرض سؤالاً مختلفاً وأكثر إلحاحاً: كيف ننتقل من منطق الاصطفاف والرهان إلى منطق الشراكة الوطنية، ومن إدارة الصراع إلى بناء الدولة؟
الواقع السوري لا يسمح بإجابات مبسّطة أو أخلاقية مجردة. فالسلطة القائمة في دمشق لا تزال انتقالية في بنيتها، مثقلة بإرث طويل من الشكوك والخوف المتبادل، فيما تعيش مناطق أخرى توترات تعكس هشاشة التسويات القائمة وحدودها. والتطورات الأخيرة في حلب، لا سيما سيطرة الجيش السوري على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لم تكن مجرد حدث عسكري، بل مؤشراً سياسياً بالغ الدلالة. إذ أظهرت بوضوح أن إدارة المناطق بوصفها أمراً واقعاً مسلحاً من دون تسوية سياسية راسخة تبقى بطبيعتها هشّة وقابلة للانهيار مع أي تحوّل في ميزان القوى.
في هذا السياق، تتجاوز إشكالية العلاقة بين السلطة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية حدود الخلاف الإداري أو التفاوضي، لتلامس جوهر السؤال حول شكل الدولة نفسها. فسورية، إن كان لها أن تُبنى من جديد، لا يمكن أن تُدار بوصفها غنيمة ولا فسيفساء كيانات متجاورة تحكمها الوقائع العسكرية أو الخصوصيات المغلقة. إنها مساحة وطنية مشتركة، والاعتراف بهذه الحقيقة هو نقطة الانطلاق لأي مشروع قابل للحياة. فلا سلطة، ولا جماعة، ولا أكثرية عسكرية تملك حق احتكار تعريف الدولة أو تقرير مستقبلها، تماماً كما لا يستطيع أي مكوّن حماية حقوقه عبر الانفصال المقنّع أو تثبيت وقائع خارج الإطار الوطني العام.
السلطة في دمشق لا تزال انتقالية في بنيتها، مثقلة بإرث طويل من الشكوك والخوف المتبادل، فيما تعيش مناطق أخرى توترات تعكس هشاشة التسويات القائمة وحدودها
الشراكة الوطنية، في معناها الحقيقي، لا تُختزل في تقاسم النفوذ، بل تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية بوصفه العقد الجامع. وهذا المبدأ لا يتحقق بالخطاب وحده. فقد أثبتت التجربة السورية أن الشعارات، حين لا تُترجم إلى ممارسات، تتحول إلى أدوات إقصاء جديدة. فالدولة لا تُعاد عبر المؤتمرات فقط، بل من خلال استعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة، وبين الفرد والمجال العام. وإعادة الإعمار ليست أسمنتاً وحديداً بقدر ما هي إعادة بناء الإنسان، وتعزيز التعليم، وفتح المجال العام، وترسيخ دولة القانون، وعدالة لا تقوم على التشفي أو الثأر، بل على المحاسبة القانونية والإصلاح ومنع تكرار الانتهاكات.
ضمن هذا الإطار، تبرز تجربة "قسد" بوصفها حالة اختبار حقيقية لفكرة الشراكة. فالقضية الكردية في سورية هي، في جوهرها، قضية حقوق مواطنة لا تقبل الإنكار أو التهميش. غير أن تحويل هذه الحقوق إلى مشروع منفصل عن الدولة السورية لا يقل خطورة عن تجاهلها. فالنموذج القائم في مناطق سيطرة "قسد" يتضمن هياكل إدارية ومجالس محلية وتمثيلاً شكلياً لبعض المكونات، لكنه يفرض في المقابل قيوداً واضحة على الحريات السياسية. لا يُسمح بالتظاهر الحر، ولا يُتاح التعبير العلني عن الرأي المخالف، ويبقى القرار الفعلي متركزاً في بنية عسكرية–سياسية واحدة، فيما تُدار المشاركة المدنية ضمن سقوف محددة سلفاً. وهذا الواقع يجعل الحديث عن ديمقراطية مكتملة أمراً غير دقيق، ويطرح تساؤلات جدية حول قابلية هذا النموذج للاندماج في دولة وطنية جامعة.
ولا يعود التوتر مع دمشق فقط إلى نقص الضمانات أو انعدام الثقة المتبادلة، بل إلى اختلاف عميق في تصور شكل الدولة وحدود السلطة. فثمة تحفّظ بنيوي داخل مشروع "قسد" تجاه الدولة المركزية، وقلق من أي صيغة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على النموذج القائم. غير أن الإصرار على تثبيت أمر واقع منفصل، في لحظة انتقالية تتغير فيها المعادلات الإقليمية والدولية، قد لا يحفظ المكتسبات بقدر ما يعرّضها للتآكل. فعدم الانخراط في الخيارات السياسية المطروحة اليوم، مهما كانت صعبة أو غير مثالية، قد يقود مستقبلاً إلى تقليص هامش الحقوق بدل توسيعه، وإلى خسارة فرص تحويل المكتسبات الراهنة إلى ضمانات دستورية دائمة.
ويزداد المشهد تعقيداً مع التحولات الأخيرة في الإطار الدولي لمحاربة تنظيم "داعش". فمع انضمام سورية نفسها إلى هذا المسار، يُعاد رسم موقع الفاعلين المحليين في نظر المجتمع الدولي، ويتراجع الاحتكار الوظيفي الذي شكّل سابقاً مصدر قوة وحماية لبعض القوى. ومع انتهاء الأطر الزمنية للتفاهمات القائمة، وتزعزع المظلات الخارجية التي استندت إليها كيانات محلية، تتضح حقيقة أساسية: الضمانات المؤقتة لا يمكن أن تحل محل تسوية وطنية دائمة، والرهان على الوظيفة الأمنية وحدها لم يعد كافياً لتبرير استمرار نماذج حكم منفصلة عن الدولة.
وفي المقابل، تقع على عاتق السلطة في دمشق مسؤولية لا تقل أهمية. فالدعوة إلى وحدة الدولة لا تكون مقنعة ما لم تترافق مع خطوات عملية تطمئن مختلف المكونات، وفي مقدمتها الكرد، بأن الدولة القادمة ليست عودة إلى مركزية إقصائية أو حكم أمني مغلق، بل دولة قانون ومؤسسات ومواطنة متساوية فعلاً لا شعاراً. فالشراكة لا تُفرض بالقوة، بل تُبنى بالثقة، والثقة لا تولد من الفراغ، بل من سياسات واضحة تفتح المجال العام، وتحترم التعدد، وتمنع إعادة إنتاج أسباب الصراع.
الرهان الحقيقي اليوم ليس على غلبة طرف على آخر، بل على كسر الثنائية القاتلة التي حكمت سورية طويلاً: إما سلطة تحتكر، أو كيانات تنفصل
الرهان الحقيقي اليوم ليس على غلبة طرف على آخر، بل على كسر الثنائية القاتلة التي حكمت سورية طويلاً: إما سلطة تحتكر، أو كيانات تنفصل. وبين هذين الخيارين، يوجد طريق ثالث، صعب لكنه الوحيد القابل للحياة، يقوم على دولة واحدة، متعددة، مدنية، لا تُقصي الدين ولا تحكم باسمه، ولا تُعادي الخصوصيات ولا تحوّلها إلى حدود سياسية. دولة يشعر فيها الجميع بأنهم شركاء لا رعايا، ومواطنون لا جماعات مؤقتة محكومة بالخوف.
إن بناء سورية، في النهاية، ليس حدثاً سياسياً عابراً، بل مسار طويل يتطلب شجاعة في الاعتراف، وواقعية في التفاوض، وتواضعاً في ممارسة السلطة أياً كان موقعها. هو انتقال من ثقافة "نحن" و"هم" إلى ثقافة "نحن معاً، ومن منطق الانتظار والارتهان إلى منطق المسؤولية المشتركة. عندها فقط يمكن أن تتحول سورية من ساحة صراع على السلطة إلى فضاء عمل جماعي، لا يُقصي أحداً ولا يُبنى على حساب أحد، لأن الوطن لا يُبنى إلا بمواطنين أحرار ومتساوين.
Related News

أول تعليق من أشرف عبدالباقي عن مسرحية عائلة الشماشرجي
al-ain
7 minutes ago

سعيد الملا.. نجم من أصول عربية ينافس كبار أوروبا
al-ain
8 minutes ago

مؤتمر دولي في الرياض يبحث استدامة المدارات الأرضية
aawsat
12 minutes ago