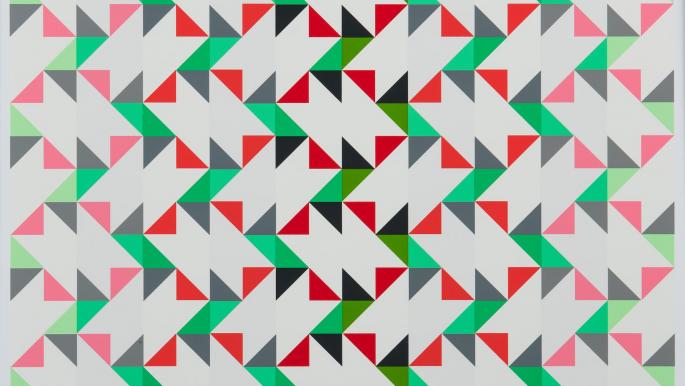
Arab
ليس التخلّف، مجرّد تأخّر زمني عن مسارات التقدّم أو عجز تقني عن مراكمة الثروة والمعرفة، بل حالة بنيوية مركّبة تُنتَج داخل المجتمع نفسه، عبر أنماط مخصوصة من الحكم، وتصورات مشوّهة للسلطة، وعلاقات مختلّة بين الدولة والمجتمع. فالتخلّف ليس نقصاً في الموارد أو الإمكانات، بل هو تعطيل ممنهج للقدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى فعل تاريخي وإنجاز تقدّمي. وهو، في جوهره، شكل من أشكال تنظيم العجز، تُعاد فيه صياغة الفشل ليغدو قاعدة للاستقرار، ويُحوَّل بمقتضاه الخلل من استثناء إلى نمط في الإدارة والتسيير. ومن ثمّة، فالتخلّف عملية سياسية وثقافية بامتياز، تُدار عبر مؤسسات وخطابات وآليات ضبط، تُفرغ الفعل العمومي من حيويته ونجاعته، وتُبقي المجتمع في حالة انتظار دائم، عاجز عن إنتاج أفقه الذاتي أو امتلاك شروط تقدّمه.
وليس التخلّف في السياق التونسي معطىً طبيعيّاً ولا نتيجة حتمية لمسار تاريخي مغلق، بل هو بناء اجتماعي، إداري، سياسي، اقتصادي طويل المدى، تشكّل عبر تداخلٍ معقّدٍ بين أنماط الحكم، واختيارات النخب، وحدود الوعي الجمعي، وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالتخلّف، في هذا المعنى، ليس حالة نقصٍ في الموارد أو في الذكاء الجمعي، بل هو نمط في سوء إدارة الإمكانات، وإنتاج البيروقراطية، وإعادة تدوير الفشل ضمن منطق يبدو مستقراً لكنه هشّ في جوهره. من هنا، فإن الحديث عن صناعة التخلّف لا ينطلق من توصيف انطباعي، بل من تحليل بنيوي لمسار تشكّل الدولة الحديثة في تونس، وللكيفية التي جرى بها تحويل السياسة من أداة للتطوّر إلى أداة لتكريس الوضع السائد والشد إلى الخلْف.
لقد نشأت الدولة الوطنية في تونس في سياق ما بعد الاستعمار وهي تحمل تناقضاً تأسيسيّاً. فمن جهةٍ، رفعت شعارات التحديث والعقلانية وبناء المؤسّسات، ومن جهة أخرى ورثت منطق السيطرة الاستعمارية في إدارة المجتمع وضبط المجال العام. ولم يُبنَ العقد الاجتماعي على أساس مشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم، بل على معادلة الوصاية مقابل الاستقرار. وبذلك تأسست الدولة على اعتبارها جهازاً فوقياً يحتكر القرار ويُعيد توزيع الامتيازات وفق منطق الولاء، لا على اعتبارها تمثيلا للإرادة العامة. ومنذ تلك اللحظة المبكرة، بدأ التخلّف يتخذ شكله السياسي: دولة متماسكة في ظاهرها، لكنها هشّة في علاقتها بمجتمعها، عاجزة عن تحويل السلطة إلى تنمية، أو الانضباط إلى عدالة.
ليس التخلّف قدراً محتوماً، بل حالة يُمكن تجاوزها. وذلك يقتضي في السياق التونسي شجاعة فكرية، وقطيعة مع الأوهام المريحة
وفي هذا السياق، لم يكن التخلّف انقطاعاً عن مسار التحديث، بل كان شكله المشوّه، فبدل أن تُنتج الدولة نُخَباً معرفية قادرة على النقد والتجديد، أعادت إنتاج نخب إدارية وسياسية وظيفتها الأساسية تبرير القائم وإدارته لا مساءلته. وهكذا تحوّلت السياسة إلى حقلٍ مغلق، تحكمه توازنات دقيقة بين السلطة والامتثال، وتُقصى منه كل محاولة لتوسيع أفق المشاركة أو إعادة تعريف المصلحة العامة. ولم يكن هذا الإقصاء قمعيّاً ومباشراً دائماً، بل غالباً ما اتخذ شكل الاحتواء، والتدجين، والتهميش، وتفريغ المفاهيم من محتواها التقدّمي.
وعلى امتداد عقود من حُكم الحبيب بورقيبة وخلفه ابن علي، لم تكُن السلطة أداة لتنظيم الاختلاف، والتداول على الحُكم. بل ظلّت غاية في ذاتها، تبرّر وجودها بسَطوتها، وإنتاج خطاب مكرّر، لا يُبالي بتغيّر الأجيال والسياقات. ففي كل مرحلة، كان يُعاد إنتاج الخوف من التعدّدية، من الفوضى، من الانقسام، من المجهول. وبتعلّة الخوف، جرى تعليق السياسة، وتأجيل الإصلاح، وتهميش المجتمع المدني، حتى غدا الاستبداد هو القاعدة، والركود العام هو الوضع الطبيعي.
ومع اندلاع الثورة، ارتفعت القداسة عن السياسة، ومارس التونسيون حقّهم في التنظّم والتعبير والاحتجاج، واختاروا ممثليهم في الهيئات السيادية في كنف الحرّية، ومارسوا التداول على الحكم سلميا. غير أنّ تلك اللحظة، على عمقها الرمزي، لم تُستثمر في تفكيك منطق السلطة، بل في إعادة توزيعه. إذ سرعان ما تحوّلت الحرية إلى ساحة صراع، والديمقراطية إلى تقنية حكم بلا مضمون اجتماعي، والسياسة إلى مسرح للاستقطاب بدل أن تكون أفقاً لبناء العيش المشترك. وهكذا، أُفرغت التجربة من بعدها التأسيسي، وأُعيد إنتاج التخلّف بلغة جديدة، أكثر ليونة، لكنها لا تقل قسوة في نتائجها.
سرعان ما تحوّلت الحرية إلى ساحة صراع، والديمقراطية إلى تقنية حكم بلا مضمون اجتماعي، والسياسة إلى مسرح للاستقطاب
ومع قيام حركة 25 جويلية (يوليو/ تموز)2021، ظنّ كثيرون أنّها ستكون تصحيحاً لمسار الثورة، وتحقيقاً للتنمية الشاملة، وترسيخا للديمقراطية. لكنّ ما حصل لاحقاً، بحسب ملاحظين، كان استعادة ملامح نظام رئاسوي مطلق. فقد أُعيد تقديم الدولة بوصفها كياناً مُنقذاً، وجرى استدعاء خطاب شعبوي حاد، قسّم المجتمع إلى فاسدين وأبرياء، ومتآمرين ومخلصين، ووطنيين وخونة، واختزل الأزمة في أشخاص لا في بنى. ولم تُطرح بعُمْق وموضوعية الأسئلة الكبرى المتعلقة بنموذج التنمية أو العدالة الاجتماعية أو طبيعة العلاقة بيْن الحاكم والمحكوم، بل جرى الالتفاف عليها بخطاب تبسيطي يَعِدُ بالخلاص من دون أن يقدّم شروطه الواقعية وآلياته التنفيذية. وفي هذا المناخ، تكرّس، بحسب مراقبين، شكل جديد من التخلّف، أكثر هدوءاً لكنّه أعمق أثراً، قوامه إنهاك المجتمع بالجباية والتعقيدات الإدارية والملاحقات القضائية بدل قمعه مباشرة، وتفريغ السياسة من معناها بدل منعها، والحدّ من هامش التعبير عبر استخدام المرسوم الرئاسي عدد54.
اقتصادياً، لم يكن الوضع أقل تعقيداً. فالاقتصاد التونسي، الذي ظل لعقود رهين نموذج هشّ، لم يشهد بعد 2011 أي مراجعة جذرية، بل ازداد ارتهاناً للخارج، وتعمّق اختلاله الداخلي. ومع غياب رؤية إنتاجية واضحة، تحوّل الاقتصاد إلى إدارة للأزمات، تُسكن أعراضها من دون معالجة أسبابها. ولم تعد البطالة والفقر ظواهر اجتماعية فحسب، بل باتت أدوات صامتة لإعادة ترتيب الطاعة، حيث يُدفع الأفراد إلى القبول بالهشاشة بوصفها قدراً لا مفرّ منه.
أمّا الإدارة، التي يُفترض أن تكون العمود الحيوي للدولة، ورافعة للتنمية، فما انفكّت مسكونة بالجمود، عصيّة على التجديد. ورغم دعوات الرئيس قيس سعيّد باستمرار إلى إصلاح المرافق العمومية، وإلى الحدّ من البيروقراطية، وقضاء شؤون المواطنين في وقت قياسي، لا تجد تلك الدعوات غالباً طريقها إلى التنفيذ، وتتعثّر في أروقة الإدارة العميقة، وما زال المواطن يجد صعوبة في الحصول على خدمات القُرب. ودليل على ذلك أنّي ما زلت أكابد منذ زهاء العامين للحصول على عدّاد كهرباء، من دون جدوى، فيما أثقلت البيروقراطية الإدارية كاهلي بشروط تعجيزية، لا طاقة لي بها، وامتنعت عن تلبية مطلبي بالنفاذ إلى المعلومة. وهو ما يُخبر بأنّنا إزاء إدارة تُطبّع مع التعطيل، وتنأى عن الشفافية، وترى نفسها فوق القانون، باعتبار أنّ أحكام المحكمة الإدارية ضدّها غيْر مُلزمة، والموفّق الإداري مجرّد ساعي بريد بيْن الإدارة والمواطن، ولا يمْلك القدرة على تغيير قراراتها.
أُعيد تقديم الدولة بوصفها كياناً مُنقذاً، وجرى استدعاء خطاب شعبوي حاد، قسّم المجتمع إلى فاسدين وأبرياء، ومتآمرين ومخلصين، ووطنيين وخونة
كما كشفت الأمطار الغزيرة التي راح ضحيّتها أخيراً خمسة مواطنين، فيما تضرّرت منازل آخرين وأملاكهم هشاشة البُنى التحتية والخَدمية، وعجز الأجهزة الإدارية الحكومية والجهوية عن استباق المخاطر والاستجابة لها فوراً. وفي ذلك تطبيع مع التخلّف لا محالة. ومع أنّ رئيسة الحكومة الحالية التي تولّت حقيبة وزارة التجهيز مدّة ثلاث سنوات وكانت موظّفة سامية فيها لأكثر من ثلاثة عقود، وكذا الشأن بالنسبة لوزير التجهيز الحالي الذي عمل في مصالح الوزارة طويلاً، فإنّ الفريق الحكومي لم يبادر بتعصير البنى التحتية رغم أنّ تونس قد تحصّلت على قروض مهمّة في هذا الخصوص من السعودية والاتّحاد الأوروبّي خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبدا أنّ بعض الولاة الذين يحظون بامتيازاتٍ عدّة وصلاحيات جمّة، والحريصين على استعراض أنشطتهم يوميّاً على صفحات "فيسبوك" حتّى يراها رئيس الجمهورية، لم يبذلوا الجهد الكافي للتوقّي من الكوارث الطبيعية، ولنجدة المواطنين، وتلبية حاجياتهم اليومية. ولم يجد المنكوبون سوى حضن قيس سعيّد ليواسيهم ويمتصّ غضبهم.
شهدت تونس، بعد2011، انفراجاً نسبيّاً في المجال الحقوقي، لكنه ظل هشّاً، ولم يترسخ مفهوم الحقوق بوصفه ثقافة عامّة، وأساسًا للعقد الاجتماعي. وبعد 25 يوليو/ تموز 2021، شهدت البلاد، بحسب مراقبين، تراجعاً لافتاً، لا يقوم على القمع الفجّ بقدر ما ينْبني على التطبيع مع الاستثناء، فجُلّ الحقوق لم تُلغَ، لكنّها أُفرغت من مضمونها، وأُعيد تعريفها وفق منطق الطوارئ الدائمة. وعلى التدريج، يجدّ بعضهم في ترويج اعتبار بعض الحريات العامّة والخاصّة منحة من السلطة لا هِبة من الثورة، واعتبارها ترَفاً، يُستغنى عنه في زمن الأزمات، لا حقّاً دستورياً، طبيعياً، دائماً. وفي ذلك تكريس لمطلب الرجوع إلى الوراء.
ختاماً، ليس التخلّف قدراً محتوماً، بل حالة يُمكن تجاوزها. وذلك يقتضي في السياق التونسي شجاعة فكرية، وقطيعة مع الأوهام المريحة، واعتبار الدولة أداة خدمةٍ لا أداة ردْع محض، والإيمان بأنّ المواطن فاعلٌ لا رعية، وأنّ التقدّم لا يُمنح، بل يُبنى عبر الفعل الجماعي، والوعي النقدي، والإيمان العميق بأنّ الكرامة والحرية والعدالة ليست مطالب ثانوية، بل أساس الاجتماع المدني نفسه.
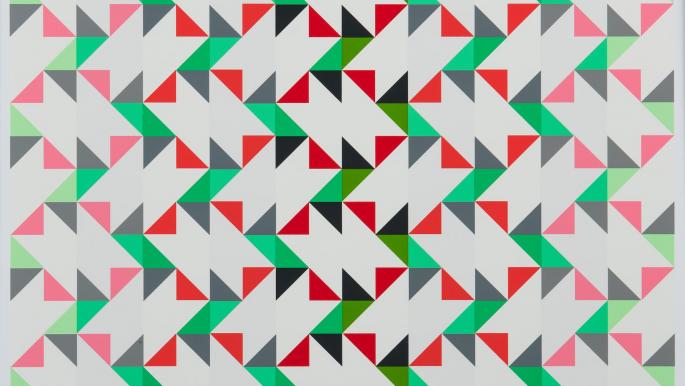
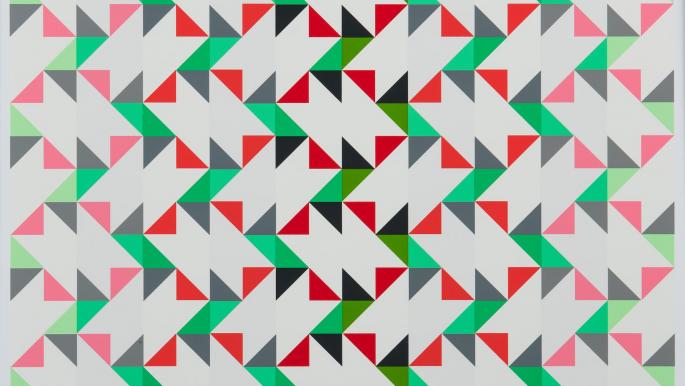
Related News

«أم الصفقات» بين الهند وأوروبا لكسر «حصار ترمب»
aawsat
30 minutes ago

تحضيرات لمؤتمر دولي حول السودان في واشنطن
aawsat
34 minutes ago


